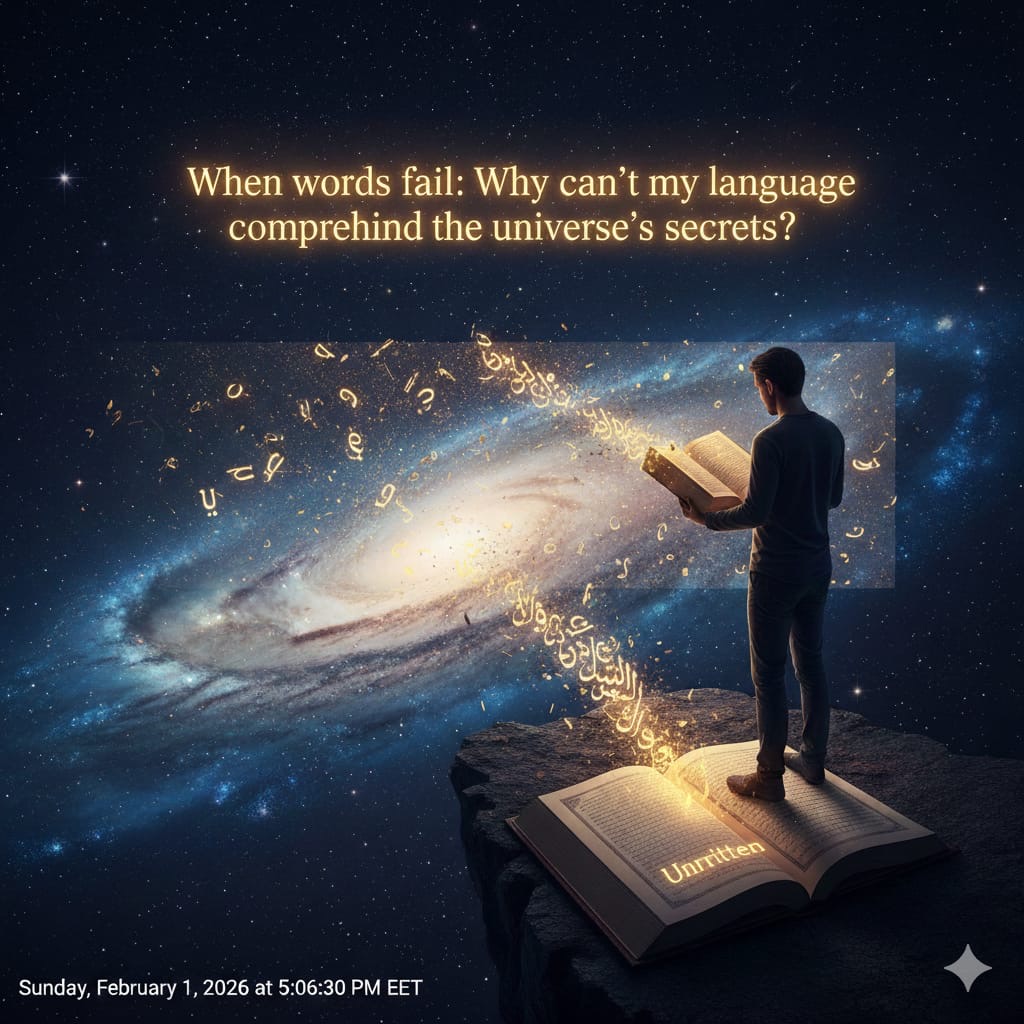
بقلم الياس عيسى الياس- ديمقراطيا نيوز
كم مرةً وقفتُ فيها أمام سماءٍ مرصعة بالنجوم، أو غصتُ في تأمل لغز الأزل، فشعرتُ أن لساني قد تجمد، وأن كلماتي عاجزة تماماً عن مجاراة ما يراه قلبي؟ في تلك اللحظات، أدركتُ أن صمتي لم يكن مجرد ارتباك عابر، بل هو اعترافٌ ضمني بحقيقة علمية وفلسفية كبرى أواجهها: أنا أحاول قياس المحيط بملعقة صغيرة. إن أزمتي كإنسان تكمن في محاولتي المستمرة لسجن “اللانهاية” داخل “قاموس”؛ فأنا أستخدم لغتي البشرية التي ولدت من رحم احتياجاتي المادية واليومية المحدودة، وأقحمها قسراً لوصف مفاهيم تتجاوز الزمان والمكان. أجدني دائماً في معركة معرفية خاسرة، تخوضها حروفي “الزمنية” أمام عظمة “المطلق” وجدار “الأزل” الصامد.
صدمتي المعرفية مع كورت غوديل
لطالما آمنتُ، كغيري، بأن المنطق والرياضيات هما اللغة النهائية التي يمكنها فك شفرة كل شيء في الوجود. كنتُ أظن أننا إذا امتلكنا الأدوات الصحيحة، سنستطيع يوماً ما كتابة “معادلة لكل شيء”. لكنني حين تعمقتُ في تاريخ العلم، اصطدمتُ بعقبة مذهلة وضعها العالم “كورت غوديل” فيما يُعرف بـ “مبرهنات عدم الاكتمال”.
لقد فعل غوديل شيئاً لا يقل عن “هدم المعبد” على رؤوسنا نحن عشاق المنطق الصارم؛ فقد جعل المنطق يعترف بعجزه أمام نفسه. ولكي أفهم كيف فعل ذلك، استلهمتُ فكرة بسيطة تشبه “مفارقة الكذاب”؛ تخيل لو أنني قلتُ لك: “جملتي هذه لا يمكن إثبات صحتها”. فكر معي: إذا كانت جملتي صادقة، فهذا يعني أننا فعلاً لا نستطيع إثباتها، وبذلك أكون أمام “حقيقة” لا يطالها “برهان”. أما إذا كانت كاذبة، فسنقع في فخ التناقض.
لقد كشف لي غوديل أن “الحقيقة” ليست مرادفة لـ “البرهان”، وأن الواقع كائن عملاق يتجاوز قفص لغتي ومنطقي. أدركتُ حينها أنني مهما طورتُ من لغات، سأظل مثل شخص يحاول رسم المحيط كاملاً وهو يقف على الشاطئ؛ فرشاتي لن تصل للأعماق، ولوحاتي لن تسع الأفق.
جغرافيا الزمكان: حين تتعثر الخطى في “نسيج” الوجود
دائماً ما أجد نفسي أقع في فخٍ لغوي غريب كلما حاولتُ التفكير في “خلق الكون”. أسأل ببساطة: “ماذا كان يوجد قبل لحظة الانفجار العظيم؟”، ثم أكتشف أن سؤالي هذا، برغم منطقيته الظاهرية، هو “خطأ لغوي” فادح! لماذا؟ لأن الفيزياء تخبرني أن “الزمن” نفسه ولد في تلك اللحظة. فكلمة “قبل” هي ظرف زمان، ولا يمكنني استخدام الزمان لوصف مرحلة “عدم وجود الزمان”. إن محاولتي قول “قبل بداية الزمن” تشبه تماماً سؤالي: “ماذا يوجد شمال القطب الشمالي؟”؛ الجواب ليس مكاناً مخفياً، بل الجواب أن سؤالي نفسه فقد معناه بمجرد وصولنا إلى القمة.
الأمر لا يتوقف عند البداية فقط، بل في ماهية “الزمان” الذي أعيشه. لقد أدركتُ أن الحقيقة تكمن في نسيج واحد لا يمكن فصل خيوطه، وهو “الزمكان”. لكي أتخيل هذا المفهوم، توقفتُ عن رؤية الكون كغرفة فارغة، وبدأتُ أتخيله كـ “قطعة قماش مطاطية” مشدودة، حيث المادة والجاذبية تقومان بطي هذا النسيج وتشكيله. هنا تنهار لغتي تماماً؛ ففي عالم “الزمكان”، الزمان ليس “نهراً يتدفق” من الماضي نحو المستقبل كما تصفه أشعاري، بل هو “بُعد هندسي” كونيّ غائر.
أدركتُ حينها أن لغتي تعمل كـ “سكين” حاد؛ فهي تُقطّع الواقع المتصل إلى قطع صغيرة (ماضٍ، حاضر، مستقبل) لكي يستطيع عقلي استيعابها، لكنها في هذا التقطيع تُفقدني رؤية “اللوحة الكاملة”. لغتي “مسطحة” تحاول وصف كون رباعي الأبعاد، وكأنني كائن يعيش على ورقة مسطحة ويحاول عبثاً وصف تجاعيد الكرة.
لغة الرمز وصمت الإشراق
عندما وجدتُ أن الكلمات العادية تخذلني، اكتشفتُ أننا كبشر اخترعنا “طرقاً بديلة” للتعبير عن العظمة التي لا تُوصف. في الرياضيات، وجدتُ حلاً ذكياً؛ بدلاً من أن أقضي قروناً في وصف “اللانهاية” بالكلمات، اخترعتُ لها رموزاً مجردة. لكن الرياضيات، برغم دقتها، تظل لغة “باردة”؛ هي تخبرني “كيف” يعمل الكون، لكنها لا تشرح لي “لماذا” أشعر بالهيبة تجاهه. إنها تعطيك “خريطة” للمحيط، لكنها لا تمنحك شعور الماء على جلدك.
على الجانب الآخر، وجدتُ طريقاً يذهب إلى ما هو أبعد من الرموز؛ طريق الصوفية والتأمل. لقد أدرك هؤلاء مبكراً أن “الكلمات هي مجرد أقفاص”. إذا أردتُ أن أصف “الحب” أو “الجلال”، فكلما تكلمتُ أكثر، ضاع المعنى مني أكثر. لذا، تعلمتُ منهم أن الحقيقة لا تُقال، بل تُعاش. هم لا يحاولون “تعريف” اللانهاية، بل يفتحون قلوبهم لاستشعارها. وكما أقول دائماً لنفسي عندما أقف أمام مشهد مهيب: “كلما اتسعت رؤيتي، ضاقت عبارتي”.
لماذا تخذلني الحروف؟
لطالما تساءلتُ: لماذا تبدو لغتي قوية جداً حين أطلبُ كوباً من القهوة، بينما تصبح هزيلة و”هشة” بمجرد أن أرفع عينيّ نحو الثقوب السوداء؟ وجدتُ أن الإجابة تكمن في طبيعة لغتي نفسها؛ فهي تعمل مثل “طابور” خطي طويل، بينما الكون يحدث في “دفقة واحدة” هائلة ومحيطة. محاولتي لوصف اللانهاية بالكلمات تشبه محاولة تمرير مياه المحيط بأكمله عبر “قشة” صغيرة.
لقد اكتشفتُ أن مفرداتي هي ابنة بيئتي البسيطة؛ كلمات مثل (فوق، تحت، بدأ، انتهى) ولدت لتساعدني على العيش فوق هذه الأرض الصغيرة. وعندما أحاول إقحام هذه الكلمات في “أسرار ما قبل الخلق”، أرتكب “خطأً فئوياً”. لغتي خُلقت للبقاء، للصيد، وللبناء، ولم تُصمم أبداً لتفك شفرات “الوجود المطلق”. نحن نحاول استخدام “جهاز لاسلكي” بسيط للاتصال بآخر نقطة في المجرة؛ الخلل ليس في الإشارة، بل في قدرات الجهاز الذي بين أيدينا.
في جمالية نقصي.. أجدُ كمالي
في نهاية رحلتي مع هذه الحروف، أدركتُ أن اعترافي بعجز لغتي ليس دعوة للاستسلام، بل هو دعوة مفتوحة لـ “الدهشة”. لقد فهمتُ أخيراً أن هذا “النقص” في كلماتي هو المحرك الأكبر لإنسانيتي؛ فلولا ضيق اللغة، لما احتجنا لابتكار الموسيقى التي تعزف ما لا يُقال، ولما رسمنا الفن الذي يجسد ما لا يُوصف.
لقد أثبت لي العلم، وقبله تجربتي الروحية، أنني أرى أكثر مما أستطيع أن أقول. الحقيقة المطلقة كائنٌ حرّ لا يمكنني سجنه بين غلافي قاموس. إنني لا ألمس عظمة الوجود حين أجد الكلمات المناسبة، بل ألمسها في تلك اللحظة التي أصمتُ فيها تماماً، مدركاً أن “عجزي” عن الوصف هو في الواقع قمة إدراكي للعظمة.
ما أضيق الكلمات، وما أوسع الوجود!
